كلوديو كوردون - الأمين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية
الثلاثاء, سبتمبر 28, 2010 | مرسلة بواسطة
kaydar

في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2009، انحصر عدد يبلغ نحو 300 ألف من أبناء سري لنكا في شريط ضيق من الأرض، ما بين جيش حركة "نمور تحرير تاميل عيلام" المتقهقر وجيش حكومة سري لنكا المتقدم. ورغم ازدياد ورود أنباء الانتهاكات التي يرتكبها الجانبان، تقاعس مجلس الأمن الدولي عن التدخل، فوصل عدد القتلى إلى ما لا يقل عن سبعة آلاف، بل ذكر البعض أن عدد القتلى قد بلغ 20 ألف شخص. ونفت حكومة سري لنكا جميع الأنباء عن جرائم حرب ارتكبتها قواتها ورفضت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي، وأحجمت في الوقت نفسه عن إجراء أي تحقيق مستقل موثوق به من جانبها. ودعا "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة، ولكن ألاعيب النفوذ أدت إلى موافقة الدول الأعضاء على قرار صاغته سري لنكا، يتضمن تهنئتها على نجاحها ضد حركة "نمور تحرير تاميل عيلام". وبحلول نهاية العام، ورغم ظهور أدلة جديدة على وقوع جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات، لم يكن أي شخص قد أحيل إلى ساحة العدالة.
وقد يصعب على المرء أن يتخيل عجزاً أكمل من هذا العجز عن محاسبة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان.
وعندما تأملتُ هذا تذكرت مقدمة التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في عام 1992، وكان عنوانه "الإفلات من العقاب عن جرائم القتل". كان التقرير يتناول عدداً كبيراً من البلدان، كان زعماؤها السياسيون والعسكريون المسؤولون يأمرون بارتكاب أعمال القتل والاختفاء القسري والاغتصاب المنظم أو يتغاضون عنها ثم لا يواجهون أي تهديد بمحاسبتهم على ذلك. وكانت سري لنكا من الأمثلة البارزة على ذلك، إذ إن حكومتها آنذاك كانت قد تقاعست عن أن تحيل إلى ساحة العدالة المسؤولين عن عشرات الآلاف من حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في غمار قمعها العنيف لتمرد داخلي في الفترة من عام 1988 إلى عام 1990.
ومن ثم كان التساؤل الذي يطرح نفسه بوضوح هو: هل تغير شيء في العقدين المنصرمين؟ وإذا ما نظر المرءُ إلى سري لنكا في عام 2009، أو حتى إلى الأوضاع في كولومبيا أو غزة، فسوف يسهل عليه أن يجيب قائلاً إنه لم يتغير شيء في الواقع، وإن لم يكن الأمر كذلك فما جدوى السعي إلى المساءلة على أية حال؟ إلا إن هذه الإجابة تتجاهل التقدم المهم الذي أُحرز في أقل من 20 عاماً، على الرغم من التحديات القديمة والجديدة، والذي كان من شأنه أن أصبح من الصعب على مرتكبي الجرائم الآن أن يضمنوا الإفلات من العقاب.
نعم، إن نفوذ القانون مازال بعيداً عن الاكتمال، فبعض الحالات تتحاشى الفحص تماماً، وفي حالات أخرى تستغرق إقامة العدل زمناً أطول مما ينبغي. ولكن التقدم قد حدث. ويُضاف إلى ذلك أن نطاق الدعوة إلى المساءلة قد امتد وتجاوز المجال المألوف للإنصاف من أعمال القتل أو التعذيب، فأصبح يشمل الحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية في الغذاء والتعليم والمأوى والصحة، وهي الحقوق التي نحتاجها جميعاً لنحيا حياةً كريمة.
المساءلة ـ الإنجازات
تعني المساءلة أن يتحمل المرء مسؤولية عمل قام به، أو تقاعس عن القيام به، وله عواقب مباشرة على الآخرين. وهذا المفهوم واسع ومتعدد: إذ يمكن الحديث عن المساءلة السياسية، التي تُوضع على المحك، مثلاً، خلال الانتخابات؛ أو عن المساءلة الأخلاقية، التي قد تُقاس، مثلاً، بمعيار قيم مجتمع من المجتمعات.وتركز المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في المقام الأول على المساءلة القانونية. فللأفراد حقوق لابد من النص عليها وحمايتها بالقانون؛ وأصحاب السلطة عليهم واجبات، يثبتها القانون أيضاً، وتنص على احترام حقوق الأفراد وحمايتها وتلبيتها..
وضمان المساءلة مهم لأنها، أولاً وقبل أي شيء، تعني أن الذين أُضيروا يتمتعون بالحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدل. فلابد للضحايا وأقاربهم أن ينالوا الإقرار بأوجه الظلم التي كابدوها وأن يشهدوا محاسبة المسؤولين عنها. وإذا كان للضحايا أن يتلقوا التعويض، فإن معرفة حقيقة الجريمة، وهوية من ارتكبها والسبب في ارتكابها، لا تقل في أهميتها عن إحالة المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.
وتتيح المساءلة لنا أيضاً أن نتطلع إلى المستقبل. فهي تمثل بعض الردع للذين قد يرتكبون جرائم، وتمثل أساساً يتيح بناء الإصلاحات في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات الدولية. ومن شأن آليات المساءلة ذات الكفاءة والفعالية أن تساعد الدول على وضع سياسات أفضل وسَنِّ قوانين أرقى، ورصد تأثير هذه وتلك في حياة الناس.
وفي غضون العقدين الأخيرين، نجحت حملة عالمية في إنشاء دور للعدالة الدولية. وكان من بين منجزاتها إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية" عام 1998 على أسس المحاكم الدولية السابقة التي تناولت جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة، وفي رواندا.
وقد مثَّل عام 2009 نقطة تحول، إذ شهد صدور إذن بالقبض على رئيس دولة لا يزال في السلطة، وهو الرئيس السوداني عمر البشير، وصدر الإذن عن "المحكمة الجنائية الدولية" بخصوص خمس تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل العمد، والإبادة، والنقل القسري للسكان، والتعذيب، والاغتصاب)، وتهمتين تتعلقان بجرائم الحرب (فيما يتصل باستهداف المدنيين).
وبحلول نهاية عام 2009، كان المدعى العام في "المحكمة الجنائية الدولية" قد فتح التحقيق في ثلاث قضايا أحالتها إليها الدول التي وقعت فيها الجرائم، وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ بالإضافة إلى قضية أخرى أحالها مجلس الأمن (بخصوص الوضع في دارفور بالسودان). كما طلب المدعي الترخيص له من دائرة التحقيق السابق للمحاكمة بفتح تحقيق آخر (بخصوص كينيا). واستدعت "المحكمة الجنائية الدولية" أحد زعماء الجماعات المسلحة في دارفور، وأصدرت أذوناً بالقبض على أحد قادة الميليشيات ومسؤول حكومي بارز بالإضافة إلى رئيس الجمهورية في السودان، كما أصدرت أذوناً بالقبض على زعماء جماعات مسلحة في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وتُعد هذه خطوات مهمة على طريق تنفيذ المبدأ الذي يقول إن جميع مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية لابد أن يُحاسبوا على قدم المساواة، سواء كانوا ينتمون إلى قوات الحكومات أو قوات أخرى.
وخلال السنوات الأخيرة، وسَّع المدعى العام في "المحكمة الجنائية الدولية" النطاق الجغرافي لعمله، إذ بدأ الفحص التمهيدي لأربع حالات خارج إفريقيا، وهي أفغانستان وجورجيا وكولومبيا، والنزاع الذي دار في عام 2008 و2009 في غزة وجنوب إسرائيل.
وكان من شأن إجراءات تصديق الدول (التي بلغ عددها 110 دول بحلول نهاية عام 2010) على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" أن حفزت الدول على إصلاح قوانينها الوطنية حتى تقضي بأن تتمتع المحاكم الوطنية باختصاص النظر فيما يعتبره القانون الدولي جريمة، وتسمح بمحاسبة المشتبه فيهم خارج بلادهم إذا كانوا بمنجاة من العقاب داخلها، وفي هذه الحالة وحدها، وهو أمر ذو أهمية بالغة. وقد شهد عام 2009 بعض النكسات في إرساء الولاية القضائية العالمية، على نحو ما حدث في إسبانيا التي اتخذت قراراً بالاقتصار على نظر القضايا التي يكون الضحية فيها مواطناً إسبانيا. وبالرغم من ذلك، فقد تقدم عدد من المحامين بدعاوى، وكان بعضها قيد النظر أمام المحاكم الوطنية في مناطق شتى من الأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا. ففي ديسمبر/كانون الأول، قدمت منظمتان غير حكوميتين في جنوب إفريقيا طعناً أمام القضاء في تقاعس السلطات عن فتح تحقيقات، بموجب قانون الولاية القضائية العالمية في جنوب إفريقيا، بخصوص ما زُعم أنها جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في زمبابوي على أيدي أفراد عُرف أنهم يزورون جنوب إفريقيا. وبحلول نهاية العام كانت أكثر من 40 دولة قد سَنَّتْ تشريعات منذ عام 1998 للحفاظ على الولاية القضائية العالمية بخصوص الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي، أو لتعزيز هذه الولاية القضائية العالمية، وساعدت بذلك في سد جزء صغير من فجوة الإفلات من العقاب على مستوى العالم.
وأدت أمثال هذه التحقيقات والدعاوى القضائية إلى تغيير نظرة الحكومات والجمهور إلى الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي. ويزداد باطراد إدراك حقيقة هذه الحالات: أي إدراك أنها جرائم خطيرة لابد من التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، لا قضايا سياسية يمكن تسويتها من خلال القنوات الدبلوماسية. ولما كنتُ قد ناضلتُ مع زملائي نضالاً شاقاً من أجل محاسبة الرئيس الشيلى السابق أوغستو بينوشيه، عقب القبض عليه في لندن عام 1998، فإنني أجد بصفة خاصة ما يدعو إلى التفاؤل في هذا التغيير في النظرة والإدراك.
فعلى امتداد أمريكا اللاتينية، تعيد المحاكم الوطنية والحكومات فتح التحقيقات في جرائم التي طالما حجبتها قوانين العفو. وتدل هذه التطورات على أنه حتى بعد انقضاء عقود على وقوع الأحداث، ورغم قوانين العفو المتعددة وغيرها من التدابير الرامية لعرقلة رفع الدعاوى القضائية، فإن المجتمع المدني قادر على مواصلة الكفاح في سبيل تحطيم الحواجز القائمة أمام الكشف عن الحقيقة، وإقرار العدالة، ودفع التعويضات.
وكان من بين الأحكام العديدة التي تُعتبر علامات بارزة الحكم الصادر في إبريل/نيسان 2009 بإدانة رئيس بيرو السابق ألبرتو فوخيموري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو الحكم الذي أرضى إلى حد ما أقارب الذين اختطفتهم وعذبتهم وأعدمتهم خارج نطاق القضاء بعض الفرق العسكرية في ثلاث حالات وقعت في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة العليا في أوروغواي ببطلان وإلغاء قانون العفو الذي صدر لتوفير الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أواخر الثمانينيات، بسبب تناقض هذا القانون مع التزامات أوروغواي بموجب القانون الدولي. وعندما اقترب عام 2009 من نهايته، بدأ وكلاء النيابة في الأرجنتين في تقديم الأدلة في محاكمة من أهم المحاكمات التي عُقدت منذ سقوط الحكم العسكري (من عام 1976 إلى عام 1983)، والتي حُوكم فيها 17 متهماً من أفراد القوات المسلحة والشرطة بتهمة التعذيب والاختفاء القسري والقتل العمد في "المدرسة الفنية البحرية" ذات السمعة السيئة.
وامتد نطاق السعي في سبيل العدالة فتجاوز كثيراً أمريكا اللاتينية. ففي عام 2009، على سبيل المثال، ازداد اقتراب سيراليون من التصالح مع ماضيها باختتام جميع المحاكمات التي جرت في "المحكمة الخاصة بسيراليون"، باستثناء محاكمة رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور، التي ما زالت مستمرة. وفي آسيا، انتهى الأمر أخيراً بقائد، من أكثر الذين اكتسبوا سمعة سيئة بين قادة "الخمير الحمر" في كمبوديا، إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت منذ ما يربو على 30 عاماً. وكان كينغ غويك إياف، المعروف أيضاً باسم "دوخ"، قائداً لمكتب الأمن رقم "س 21" الذي يُعتقد أنه عُذِّبَ فيه ثم قتل عدد لا يقل عن 14 ألف شخص في الفترة ما بين إبريل/نيسان 1975 ويناير/كانون الأول 1979. وكانت تلك أولى المحاكمات التي تجريها "الدوائر الاستثنائية في نظام المحاكم الكمبودية"، وهي محكمة مؤقتة، وينبغي أن تُفضي في أقرب وقت ممكن إلى نظام قضائي محلي يمارس عمله، ولكنها على الأقل أتاحت للضحايا أن يشهدوا الإقرار بمعاناتهم.
وفي عام 2009 اكتشفت حتى أقوى الدول أنها لا تستطيع إخفاء جميع أفعالها عن عين القانون. وبالرغم من أن بعض الدول الأوروبية كانت تبدي الفتور في ملاحقة الانتهاكات المرتكبة في إطار "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة، فقد قضت محكمة إيطالية، في نوفمبر/تشرين الثاني، بإدانة 22 من العاملين في "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، وضابط بسلاح الطيران الأمريكي، واثنين من عناصر "الاستخبارات الحربية الإيطالية"، لضلوعهم في اختطاف أسامة مصطفى حسن نصر (أبو عمر) من أحد شوارع مدينة ميلانو في عام 2003. وقد نُقل أبو عمر بعد ذلك إلى مصر حيث اعتُقل في مكان سري طيلة 14 شهراً وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم. وكان السبب الرئيسي لإجراء المحاكمة إصرار النيابة العامة في ميلانو على تنفيذ القانون، على الرغم من ضغوط الحكومة الإيطالية عليها بإسقاط التهم، وعلى الرغم من عدم احتجاز أي من المتهمين الأمريكيين قط أو مثوله بشخصه في المحاكمة.
وأدى وجود "المحكمة الجنائية الدولية" إلى زيادة الاهتمام الجاد بقضية المساءلة حتى في الدول التي قد يشعر فيها المسؤولون، لولا وجود هذه المحكمة، بالحصانة لأنهم لم يقبلوا رسمياً ولايتها القضائية. وقد شكل "مجلس حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة بعثةً مستقلة لتقصي الحقائق، يرأسها ريتشارد غولدستون، وهو قاض من جنوب إفريقيا وتولى من قبل منصب المدعى العام في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، وذلك للتحقيق في الانتهاكات التي زُعم وقوعها إبان النزاع في غزة وجنوب إسرائيل، والذي استمر 22 يوماً وانتهى في يناير/كانون الثاني 2009. وخلص تقرير غولدستون إلى أن القوات الإسرائيلية وحركة "حماس" (وجماعات فلسطينية أخرى) قد ارتكبت جرائم حرب، وربما أيضاً جرائم ضد الإنسانية. وأكد التقرير النتائج التي سبق أن توصلت إليها البعثات الميدانية التي أوفدتها منظمة العفو الدولية إلى غزة وجنوب إسرائيل خلال النزاع وفي أعقابه مباشرةً.
وقال تقرير غولدستون إن "طول فترة الإفلات من العقاب قد أنشأ أزمة عدالة." وجاء في توصياته إنه إذا لم يقم الجانبان بإجراء التحقيقات وضمان المساءلة، فإن على مجلس الأمن أن يمارس سلطاته ويحيل الأمر إلى "المحكمة الجنائية الدولية". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أمهلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل وحركة "حماس" ثلاثة أشهر لإثبات عزمهما وقدرتهما على إجراء تحقيقات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفيما يُعتبر نموذجاً لسرعة استجابة المجتمع الدولي، شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكرى، في 28 سبتمبر/أيلول، والتي قُتل فيها أكثر من 150 شخصاً، كما تعرضت بعض النساء للاغتصاب علناً، وذلك عندما لجأت قوات الأمن إلى العنف لقمع مظاهرة سلمية في ملعب رياضي. وخلصت لجنة التحقيق، في ديسمبر/كانون الأول، إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية قد وقعت، وأوصت بإحالة القضية إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، التي شرعت في إجراء تحقيق تمهيدي.
وأخيراً، فقد شهد العقدان الأخيران زيادةً مطردة في آليات "العدالة الانتقالية"، حيث خرجت بلدان كثيرة من لُجَّة الصراع المسلح أو القمع السياسي، الذي دام أمداً طويلاً، كي تواجه ماضيها بنماذج متفاوتة للمساءلة. ففي عام 2009، كانت إجراءات الحقيقة والمصالحة وما أعقبها من إجراءات تسير في ليبيريا، وفي جزر سليمان، وفي المغرب، وهو البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقدم على مواجهة انتهاكات الماضي بهذا الأسلوب. وقد كان من الواضح لنا كلنا، ونحن نجمع سجلات منظمة العفو الدولية الخاصة للمساعدة في هذه الإجراءات، وهي السجلات التي تغطي عقوداً من البحث بشأن حالات فردية، أن المساءلة لابد أن تقترن بالكشف عن الحقيقة، إذا ما أُريد تحقيق مصالحة تقوم على أساس العدل. ولا يزال الإغراء قائماً بأن نضرب صفحاً عن الماضي، ولكن الخبرات تثبت أن السماح لمرتكبي الانتهاكات "بالإفلات من العقاب عن جريمة القتل" لا يمكن أن يؤدي إلا إلى سلام هش لا يعمر طويلاً في أكثر الأحيان.
السلطة والتسييس – عوائق إقامة العدل
إذا كان تحقيق المساءلة القانونية عن الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي قد أصبح ممكناً اليوم عما كان عليه في أي وقت مضى، فإن أحداث عام 2009 تؤكد وجود عقبتين كبيرتين تعوقان المسير إليه، ولابد من التغلب عليهما إذا ما أُريد حقاً نشر المساءلة الحقة عن الحقوق بشتى أنواعها. والعقبة الأولى هي أن الدول القوية لا تزال تقف فوق القانون، وخارج نطاق الفحص الدولي الفعال. أما العقبة الثانية فهي أن هذه الدول تتلاعب بالقانون، فتحمي حلفاءها من الفحص ولا تمارس الضغط لتحقيق المساءلة إلا عندما تقتضي ظروفها السياسية ذلك. وبهذا توفر الذرائع لدول أخرى، أو لتكتلات من الدول، بأن تضفي الطابع السياسي على العدالة بالأسلوب نفسه.وعلى الرغم من تصديق 110 دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، فلم تصادق عليها إلا 12 دولة من دول "مجموعة العشرين". وكانت إندونيسيا، وتركيا، وروسيا، والصين، والهند، والولايات المتحدة، من بين الدول التي تَنَحَّتْ جانباً عن جهود العدالة الدولية، إن لم تكن قد قوضتها عمداً.
فبعد أن أخرجت الولايات المتحدة نفسها من إطار ولاية "المحكمة الجنائية الدولية"، أصبحت تواجه قدراً أقل من الضغوط الخارجية المطالبة بالتصدي لما ترتكبه هي من انتهاكات في سياق استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب. وعندما تولى الرئيس باراك أوباما مهام منصبه وأمر بإغلاق معتقل خليج غوانتنامو في غضون عام واحد، وبوضع حد لبرنامج الاحتجاز السري واستخدام ما يسمى "أساليب التحقيق المشددة"، كانت الدلائل تبشر بالخير. ولكن بحلول نهاية عام 2009، كانت احتجاز المعتقلين في غوانتنامو لا يزال مستمراً، ولم يكن هناك تقدم يُذكر نحو مساءلة أي شخص عن الانتهاكات المرتكبة في هذا المعتقل أو في غيره من جوانب "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة.
وتحجب الصين أيضاً أفعالها عن الفحص الدولي. ففي يوليو/تموز 2009، اندلعت أعمال شغب عنيفة في أعقاب انقضاض الشرطة على مظاهرة كانت في أول الأمر سلمية، نظمها أبناء جماعة "الأوغور" العرقية في أورومتشي بإقليم شينجيانغ أوغور ذي الحكم الذاتي. وفرضت الحكومة الصينية قيوداً على سبب استقاء المعلومات، واعتقلت عدداً من المتظاهرين السلميين، وعقدت محاكمات جائرة، وأصدرت أحكاماً بالإعدام على كثيرين، ونفذت الحكم في تسعة منهم في غضون شهور من اندلاع العنف. وفي ديسمبر/كانون الأول، حكم بالإعدام على 13 آخرين، واعتُقل 94 آخرون. وبعد أعمال عنف، سُمح للصحفيين بدخول المنطقة لفترة قصيرة وفي ظل قيود، إلا إن ذلك لا يغني عن إجراء تحقيق دولي صحيح. ولم ترد الصين على الطلب الذي تقدم به "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب" لزيارة المنطقة ولا يمكن تصديق أي زعم من جانب الحكومة بضمان المساءلة ما دامت تلك المساءلة المفترضة تكتنفها السرية ويشوبها الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام.
وقد انتهت اللجنة المستقلة، التي كلفها الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق في النزاع الذي دار بين جورجيا وروسيا في عام 2008، إلى أن جميع الأطراف كانت مسؤولة عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالرغم من ذلك، فقد انتهى عام 2009 دون أن تُقْدم روسيا ولا جورجيا على محاسبة أي شخص، بينما كان زهاء 26 ألف شخص لا يزالون عاجزين عن العودة لديارهم. وكان الأمر الذي يزداد وضوحاً أن روسيا سوف تستخدم نفوذها لحماية جنودها ولحماية الإقليمين المنفصلين في جورجيا، وهما جنوب أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا من الفحص الدولي. وقد عارضت روسيا، على وجه الخصوص، تمديد التفويض لبعثتين دوليتين للمراقبة في جورجيا كانت لهما أهمية حاسمة، وتتبع أولاهما "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، أما الثانية فتتبع الأمم المتحدة. ونتيجةً لذلك، أصبحت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي هي هيئة المراقبة الدولية الوحيدة العاملة في جورجيا، ولا يُسمح لها بدخول مناطق النزاع التي باتت تخضع لسيطرة روسيا أو لسيطرة السلطات القائمة بحكم الواقع الفعلي في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وكانت إندونيسيا، وهي من البلدان ذات الوزن الاقتصادي الثقيل الذي أتاح لها الانضمام إلى "مجموعة العشرين"، قد تقاعست طوال ما يزيد على 10 سنوات عن ضمان المساءلة عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أثناء الاستفتاء على استقلال تيمور الشرقية في عام 1999 تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك أثناء فترة الاحتلال الإندونيسي السابقة التي دامت 24 عاماً. وعلى الرغم من شتى المبادرات العديدة للكشف عن الحقيقة، والتي أُجريت تحت رعاية محلية أو دولية، فإن معظم الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عام 1999 لا يزالون مطلقي السراح، بينما بُرئت ساحة جميع الذين حُوكموا في إندونيسيا.
وأما العقبة الثانية، وهي تسييس العدالة الدولية، فإنها تُخضع مسعى تحقيق المساءلة لبرنامج سياسي يتمثل في تدعيم الحلفاء وتقويض المنافسين. فعلى سبيل المثال، استخدمت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي موقعها في مجلس الأمن من أجل استمرار حماية إسرائيل من إجراءات قوية للمحاسبة عن أفعالها في غزة. وفي لفتة يتجلى فيها الانحياز السياسي، طلب "مجلس حقوق الإنسان" في بادئ الأمر أن يقتصر التحقيق على الانتهاكات التي زُعم أن إسرائيل قد ارتكبتها. إلا إن القاضي ريتشارد غولدستون، الذي عُين لاحقاً لإجراء هذا التحقيق بفضل مصداقيته، أصرَّ على أن تقوم "بعثة تقصي الحقائق" التابعة للأمم المتحدة بفحص الانتهاكات التي زُعم وقوعها على أيدي إسرائيل وحركة "حماس". ومن ناحية أخرى، لم تصوِّت أي من الدول الآسيوية أو الإفريقية في "مجلس حقوق الإنسان" ضد القرار الذي يحيي حكومة سري لنكا على مسلكها في الحرب ضد حركة "نمور تحرير تاميل عيلام".
وكان عزوف الدول القوية عن محاسبة نفسها وحلفائها السياسيين بهذه المعايير ذاتها ذريعةً سمحت لدول أخرى بتبرير أفعالها أيضاً استناداً إلى معاييرها المزدوجة، وأحياناً ما كانت هذه الدول تسوق الفكرة المضللة، وهي "التضامن الإقليمي"، واضعةً إياها فوق التضامن مع الضحايا. وليس أدل على ذلك من رد الفعلي الأولى للدول الإفريقية إزاء إذن القبض الذي أصدرته "المحكمة الجنائية الدولية" على الرئيس عمر البشير. فعلى الرغم من خطورة الجرائم التي زُعم ارتكابها، كرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي برئاسة ليبيا، في يوليو/تموز، طلبه إلى مجلس الأمن الدولي بإيقاف الإجراءات المتخذة ضد الرئيس السوداني، وقرر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لن تتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية" فيما يتعلق بالقبض عليه وتسليمه، وطلب من المفوضية الإفريقية الدعوة إلى عقد اجتماع تحضيري لمناقشة إدخال تعديلات على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، بحيث تُقدم قبل انعقاد مؤتمر مراجعتها في عام 2010.
وبعد أن تنقل الرئيس البشير بحرية بين بلدان ليست من الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي"، تلقى دعوات لزيارة تركيا ونيجيريا وأوغندا وجنوب إفريقيا وفنزويلا. ولكن ما لبثت أصوات الغضب أن ارتفعت من المجتمع المدني، فبدأ يتغير اتجاه التيار، إذ صرحت جنوب إفريقيا بأنها ستفي بالتزاماتها بموجب "نظام روما الأساسي"، وأعلنت البرازيل والسنغال وبوتسوانا صراحةً استعدادها لاعتقاله إذا وصل إليها. ومع ذلك ففي نهاية عام 2009 كان الرئيس البشير لا يزال مطلق السراح، ولا يزال يزعم أن الجهد المبذول لمحاكمته له دافع سياسي ويمثل ضرباً من التحيِّز ضد إفريقيا، ولا يزال كابوس وقوع المزيد من أحداث العنف والانتهاكات مستمراً بالنسبة لمئات الآلاف من النازحين في دارفور، كما يلوح خطر استئناف الحرب في جنوب السودان واشتداد المصاعب.
التحديات المقبلة – المساءلة عن جميع الحقوق
لا شك في أن العقبات التي تعوق تطبيق المساءلة، عن الفظائع الواسعة النطاق أثناء النزاعات أو في غضون القمع السياسي، هي عقبات حقيقية، ولكن الجدل قد حُسم على الأقل، إذ لم يعد أحد ينكر المبدأ الذي يقضي بضرورة معاقبة مرتكب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو حوادث الاختفاء القسري. ولكن عندما يتعلق الأمر بحرمان قطاعات واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه لا يوجد جهد مماثل من أجل إرساء القانون وتطبيق مبدأ المحاسبة. وقد يقول الكثيرون إن الأمر مختلف فيما يتعلق بهذه الحقوق، وهو قول صحيح في ظاهره، فإزهاق أرواح سكان مدنيين يختلف عن حرمان عدد من السكان من حقهم في التعليم، إلا إن هذا الحرمان يُعد استخفافاً بالقانون الدولي ويؤثر سلبياً على حياة السكان، ومن ثم ينبغي السعي لملاحقة المسؤولين عنه من خلال المحاسبة الدولية.وتتمثل المهمة في إقناع زعماء العالم بأن هذه المشكلة تشكل أزمة في حقوق الإنسان، ولا تقل أهميةً في هذا الصدد عن النزاع في دارفور.
ويمكن للمرء أن ينظر إلى حق الصحة، ولاسيما البلاء المتمثل في وفيات الأمهات الحوامل. فهناك أكثر من نصف مليون امرأة يلقين حتفهن كل عام بسبب المضاعفات المتعلقة بالحمل. وترتبط معدلات وفيات الأمهات الحوامل ارتباطاً مباشراً بانتهاكات حقوق الإنسان في سيراليون وبيرو وبوركينا فاسو وإندونيسيا، وليست هذه سوى قلة من البلدان التي ركزت عليها منظمة العفو الدولية في عام 2009. وعلى نحو ما شِهَدْته شخصياً في سيراليون وبوركينا فاسو، فإن حكومات تلك البلدان تقر بالمشكلة وتتخذ خطوات لمعالجتها. ولكن هذه الحكومات، بالإضافة إلى المجتمع المدني، في حاجة إلى بذل جهود أكبر لمعالجة قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تسهم في ارتفاع معدلات الوفيات التي يمكن منعها، من قبيل التمييز بسبب النوع، والزواج المبكر، وحرمان المرأة من حقوقها الجنسية والإنجابية، فضلاً عن العوائق التي تعترض سبل الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحظى هذه الدول بدعم المجتمع الدولي.
ويُقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن توفر موارد كافية يمثل شرطاً جوهرياً لتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم فهو يطلب "التلبية المطردة" لهذه الحقوق "إلى الحد الأقصى من الموارد المتاحة." ولكن ينبغي ألا تتذرع الحكومات بمسألة قلة الموارد وحسب، فمعدل وفيات الأمهات الحوامل، التي يمكن الحيلولة دون وقوعها، في بلد ما لا يعكس بالضرورة فقر هذا البلد أو ثراءه. فعلى سبيل المثال تزداد نسبة وفيات الأمهات كثيراً في أنغولا عنها في موزمبيق، على الرغم من أن موزمبيق أفقر كثيراً. وعلى غرار ذلك، فإن نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في غواتيمالا يبلغ ضعف مثيله تقريباً في نيكاراغوا، ومع ذلك فإن معدل وفيات الأمهات في غواتيمالا أعلى بكثير.
ويمكن للمرء أيضاً أن ينظر إلى الحق في السكن. فقد تناولت منظمة العفو الدولية في عام 2009 محنة عشرات الآلاف من المشردين في العاصمة التشادية نجامينا بعد إجلائهم بالقوة من مساكنهم، وكذلك محنة سكان الأحياء الفقيرة في العاصمة المصرية القاهرة، الذين ما زالوا عرضةً لخطر الموت من جراء تحت الانهيارات الأرضية وغيرها من المخاطر، وذلك بسبب عدم قيام السلطات بتوفير مساكن آمنة لهم. وفي العاصمة الكينية نيروبي، شاركت منظمة العفو الدولية في مسيرة لسكان حي كبيرا، وهو أكبر الأحياء الفقيرة في إفريقيا، وغيره من الأحياء الفقيرة، للمطالبة بحقهم في السكن الملائم والمرافق الكافية. وفي قطاع غزة، كان أحد العواقب الناجمة عن النزاع في عامي 2008 و2009، والذي ركزت عليه منظمة العفو الدولية، هو الدمار الذي لحق بعدد كبير من المنازل، واقترن باستمرار الحصار، الذي يحول دون دخول مواد البناء إلى غزة. وكانت أشد الفئات ضعفاً هي التي تتحمل أعباء هذا الحصار، الذي يُعد بمثابة عقاب جماعي، وهو الأمر الذي يُعتبر جريمةً بموجب القانون الدولي.
والعنصر الذي يشترك فيه سكان البلدان التي سبق ذكرها بشكل أكثر من غيره هو عنصر الفقر. فالفقراء هم أشد من يعانون من التمييز ضدهم، ويمثلون أوضح مجال تتبدى فيه ضرورة حماية جميع الحقوق المنصوص عليها في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ويُعد التمييز من العوامل الرئيسية الدافعة إلى الفقر، وكثيراً ما يكون العامل الذي يحدد تخصيص الإنفاق الحكومي. والواقع أن معظم الذين يعيشون في فقر في العالم، وأشد من يعانون من التمييز في القانون والممارسة العملية، من النساء. وينبغي ألا يستأثر الرجال أو الأغنياء بمزية السلامة في الحمل والمسكن والطرق الآمنة إلى المدارس أو إلى العمل.
وهناك بعض الخطوات الإيجابية التي اتُخذت لضمان المساءلة القانونية عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية. ويزداد تدخل المحاكم الوطنية لحماية هذه الحقوق والمطالبة بإدخال تغييرات في السياسات الحكومية ضماناً لتلبية الحق في الصحة وفي المأوى وفي التعليم وفي الغذاء، وهي الحقوق التي تمثل الحد الأدنى، كما إن الآليات الدولية تشجع هذه المحاكم على أن تفعل المزيد.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2009، على سبيل المثال، أصدرت محكمة العدل المنبثقة عن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، ومقرها أبوجا، قراراً يقضي بأن لجميع مواطني نيجيريا أن يتمتعوا بالحق في التعليم باعتباره أحد حقوق الإنسان. وقالت المحكمة إن الحق في التعليم يمكن فرضه قانوناً، ورفضت جميع الاعتراضات التي قدمتها الحكومة ومؤداها أن التعليم "مجرد توجه سياسي للحكومة وليس حقاً من الحقوق القانونية للمواطنين."
وهناك مثال آخر، من بلدة ميركوريا سيوتش في رومانيا، حيث تقدمت مجموعة من طائفة "الروما" (الغجر) بدعوى إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، في ديسمبر/كانون الأول 2008. ويعيش أفراد هذه المجموعة منذ عام 2004 في أكواخ وعشش معدنية بجوار محطة لمعالجة مخلفات الصرف، وذلك بعد إجلائهم قسراً من مبنى متهالك في وسط البلدة. وكانت هذه المجموعة، التي تؤيدها منظمات محلية غير حكومية، قد استنفدت جميع السبل المتاحة محلياً للإنصاف، ولم تسفر الأحكام التي أصدرتها المحاكم الوطنية لصالحهم عن أي شيء في الواقع الفعلي.
وحققت إمكانية المساءلة الدولية في هذا المجال خطوة كبرى في سبتمبر/أيلول 2009، بفتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، إذ ينص البروتوكول للمرة الأولى على إنشاء آلية دولية للشكاوى الفردية، كما ستدعم هذه الآلية الجهود الذي تبذل داخل البلدان لضمان إتاحة سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.
وقد أصبحت المساءلة الدولية المتزايدة عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية أكثرَ أهمية بالنظر إلى تضافر آثار الأزمات في مجالات الغذاء والطاقة والمال، والتي تشير التقديرات إلى أنها دفعت ملايين عديدة أخرى إلى هوة الفقر. وينبغي أن يكون احترام الحقوق الإنسانية كافةً، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جزءاً لا يتجزأ من جميع الجهود المحلية والدولية الرامية للتصدي لهذه الأزمات.
ولكن الحكومات ليست العوامل الوحيدة المساهمة في هذه الأزمة، إذ إن الشركات التجارية العالمية تزداد قوةً ونفوذاً، ومن شأن القرارات التي تتخذها هذه الشركات والنفوذ الذي تمارسه أن يؤثرا تأثيراً عميقاً على الحقوق الإنسانية للأفراد. فما أكثر الشركات التي تستغل عدم وجود تنظيم فعال للعمل، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومات القمعية، والفاسدة في كثير من الأحيان، بما يخلفه هذا من عواقب وخيمة.
وشهد العالم، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، توسيع نطاق القانون لحماية المصالح الاقتصادية العالمية، من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية للاستثمار والتجارة، والتي تساندها آليات للتنفيذ. وبينما كان بوسع المصالح الاقتصادية أن تجعل القانون أداةً تخدمها، فكثيراً ما كان المتضررون من عمليات الشركات يرون القانون وهو يتقهقر أمام نفوذ الشركات.
وقد حلَّت في ديسمبر/كانون الأول 2009 ذكرى مرور 25 عاماً على كارثة تسرب مواد كيماوية فتاكة من مصنع شركة "يونيون كاربايد" للمبيدات الحشرية في بوبال بوسط الهند. وقد أدت هذه المأساة إلى وفاة الآلاف، ولا يزال نحو 100 ألف شخص يعانون حتى اليوم من مشاكل صحية بسبب هذا التسرب. وبالرغم من الجهود التي بذلها ضحايا كارثة بوبال لالتماس العدالة، من خلال المحاكم في الهند والولايات المتحدة، فإن عملية إعادة تأهيل الضحايا ما زالت قاصرةً كثيراً عن المطلوب، ولم يحدث مطلقاً أن حُوسب أحد عن التسرب أو عن عواقبه.
ولا تزال المساءلة الفعالة للشركات أمراً نادراً. فهناك عقبات تعرقل المحاولات الرامية إلى تحقيق العدالة، وتتمثل في قصور النظم القانونية، وعدم توفر سبل الحصول على المعلومات، ونفوذ الشركات داخل الهياكل القانونية والتنظيمية، فضلاً عن الفساد والتحالف القوي بين الدول والشركات. وبالرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات، بحكم طبيعتها، تعمل عبر الحدود، فما زالت هناك عقبات كبيرة، على المستوى القانوني ومستوى الولاية القضائية، في استصدار أحكام قضائية ضد الشركات في الخارج. فالشركات العالمية تعمل في إطار اقتصاد عالمي، ولكن في غياب سيادة القانون على الصعيد العالمي.
وعلى الرغم من التحديات الهائلة، فإن عدداً متزايداً من الأفراد والتجمعات يتجه إلى رفع دعاوى مدنية في محاولة لمحاسبة الشركات، من جهة، والحصول على نوع من أنواع التعويض، من جهة أخرى. ففي نيجيريا، ظلت صناعة النفط تعمل على مدى 50 عاماً دون ضوابط تنظيمية فعالة، مما أسفر عن أضرار واسعة النطاق للبيئة ولحقوق الإنسان. وثبت أن النظام القضائي في نيجيريا يتسم بالمراوغة بالنسبة لمعظم المجتمعات التي تضررت حياتها وسبل رزقها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، وافقت محكمة هولندية على المضي قُدماً في إجراءات قضية مدنية ضد شركة "شل"، رفعها أربعة نيجيريين مطالبين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأرزاقهم من جراء تسرب النفط.
وفي إحدى قضايا التعويضات المدنية التي رُفعت في المملكة المتحدة في عام 2009 وحظيت بتغطية إعلامية واسعة، قبلت شركة "ترافيغورا" للتجارة في النفط دفع 45 مليون دولار، وذلك في تسوية خارج المحكمة مع قرابة 30 ألف شخص تضرروا من دفن النفايات السامة في أبيدجان بساحل العاج. وكانت سفينة "بروبو كوالا"، التي استأجرتها شركة "ترافيغورا"، قد نقلت النفايات إلى أبيدجان في عام 2006، ثم دُفنت هذه النفايات في مواقع شتى حول المدينة، وهو ما تسبب في مشاكل صحية مختلفة لما يزيد عن 100 ألف شخص، كما ورد أن 15 شخصاً قد تُوفوا من جراء ذلك.
وقد تكفل مثل هذه التسويات خارج المحاكم قدراً ضئيلاً من العدالة للضحايا، ولكنها كثيراً ما تتضمن قيوداً خطيرة، فضلاً عن أنها لا توفر الإنصاف أو المحاسبة بشكل كامل. ففي قضية ساحل العاج، لم تُعالج بعد جوانب جوهرية تتعلق بالأثر الذي خلفه دفن النفايات السامة على حقوق الإنسان. وما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لمعالجة الفجوات القانونية وتلك المتعلقة بالولاية القضائية، والتي تسهل في الوقت الراهن إفلات بعض الشركات من العقاب. ويتعين على الشركات، التي تُقر بشكل مطرد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، أن تدعم هذه الجهود بشكل نشط.
الخطة العالمية التالية – المساءلة عن جميع الحقوق
سوف يجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2010 لمراجعة التقدم في الوفاء بما وعدوا به من تحسين معيشة فقراء العالم، وهو المنصوص عليه في "أهداف التنمية للألفية". واستناداً إلى الأدلة المتاحة، فما زال العالم بعيداً كل البعد عن تحقيق الأهداف المحددة لعام 2015. ويتمثل ثمن هذا القصور في حرمان مئات الملايين من حقهم في العيش بكرامة، وهو ما يتجاوز مجرد التمتع بحرياتهم السياسية ليشمل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والأمن، حسبما ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ومن ثم، فإن الهدف لا يزال هو التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة.ولابد أن يُبذل جهد مماثل في الوقت الراهن لاستغلال الزخم الذي استُخدم في إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية" والآليات الدولية للعدالة، وذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من المساءلة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي الذي لم يأخذ في اعتباره حتى الآن جميع حقوق الإنسان. وثمة حاجة إلى فكر جديد. فليست الغايات المنصوص عليها في "أهداف التنمية للألفية" مجرد وعود، بل إنها تشير كذلك إلى ما التزمت به الحكومات قانوناً من أجل تلبية حقوق الإنسان الأساسية، ومن هذه الزاوية لابد من توافر آليات لمحاسبة الحكومات عن الوفاء بما التزمت به. وينبغي أن تكون هناك سبل إنصاف فعالة إذا ما تقاعست دول عن القياد بذلك.
ومما يعزز المساءلة أن تأخذ الجهود المبذولة لتحقيق "أهداف التنمية للألفية" في اعتبارها إلى أقصى حد آراء الذين يعيشون في فقر. فمن حق الأفراد أن يشاركوا فيما يُتخذ من قرارات تؤثر في حياتهم، وأن تُتاح لهم حرية الحصول على المعلومات الخاصة بهذه القرارات. والواقع أن أصحاب الحقوق أنفسهم لم يشاركوا مشاركة تُذكر في صياغة "أهداف التنمية للألفية". وينبغي أن تكفل عملية تحقيق "أهداف التنمية للألفية" أيضاً الفحص الدقيق لمسلك الحكومات التي تطبق سياسات محلية من شأنها أن تقوِّض تلبية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في "أهداف التنمية للألفية"، بما في ذلك حكومات الدول التي تتمتع بنفوذ دولي. ولابد من مساءلة جميع الحكومات، وبصفة خاصة حكومات "مجموعة العشرين" التي تنهض بدور أكبر في الزعامة العالمية، عما إذا كانت سياساتها تُترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة فقراء العالم.
وفي إطار هذا الجهد الرامي إلى تلبية جميع الحقوق الإنسانية لجميع البشر، يجب على الدوام تذكير العناصر التابعة للدول وغير التابعة لها بالتزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية. فالعالم يشهد في الوقت الراهن، أكثر من أي عصر مضى، تلاحم دعاة حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المحلي، والمحامين وغيرهم لتحقيق هذه الغاية، فهم يعملون مع من بيدهم مقاليد السلطة إذا كانت هناك أهداف مشتركة، ولكنهم قد يتحدونهم بالسعي لاتخاذ إجراءات المساءلة المؤسسية والفردية. ويزداد تنوع حركة حقوق الإنسان نفسها، كما يزداد ترابطها العالمي عبر الحدود والنظم، سعياً لتنفيذ مشروع أشمل لحقوق الإنسان.
واليوم، ونحن على أعتاب العقد الثاني من الألفية، تعمل منظمة العفو الدولية جنباً إلى جنب مع شركائها في تلك الحركة العالمية، من أجل إعادة التأكيد على قيمة الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ومن أجل التدليل على أن هذه الحقوق لا يمكن أن تُجزأ أو تُنتقص، وأنها تسهم بشكل مباشر في أن يعيش الإنسان حياةً كاملةً. وفي غمار هذا العمل، تؤكد منظمة العفو الدولية على التزامها برؤيةٍ لحقوق الإنسان تتجاوز الدول والجماعات المسلحة والشركات، وتعتبر كل فرد عاملاً من عوامل التغيير، له حقوق وعليه مسؤوليات. فلكل فرد الحق في أن يطلب من الدولة والمجتمع الاحترام والحماية وإعمال الحقوق، ولكن عليه أيضاً مسؤوليات تتمثل في احترام حقوق الآخرين، والعمل بالتضامن مع غيره للوفاء بما وعد به "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
Bookmark/Search this post with:
قسم:
تقارير
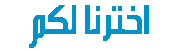 تقارير
تقارير
الكاتب

أرشيف قيدار البعشيقي
صورة مختارة









 توقيت بغداد
توقيت بغداد
0 التعليقات: